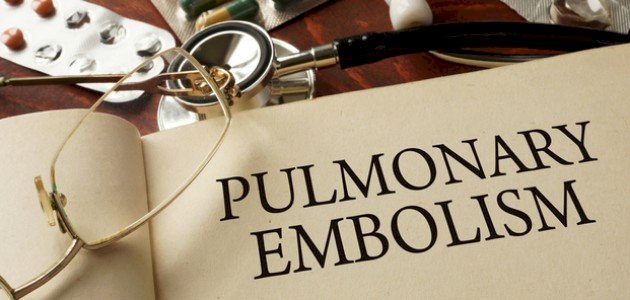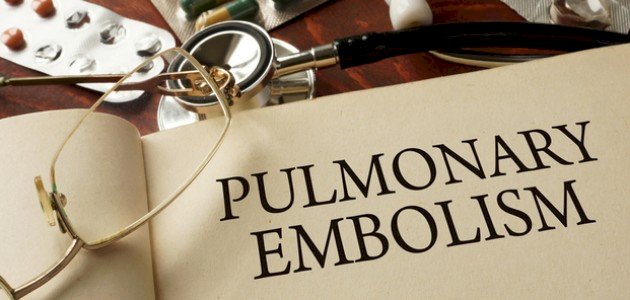محتويات
تعرف على أهم أعراض جلطة الرئة
يُطلق الأطباء على جلطة الرئة اسم الانصمام الرئوي Pulmonary Embolism، وهي مشكلة صحية يعاني خلالها المصاب من انسداد في أحد الشرايين في الرئتين، وغالبًا ما يحدث هذا الانسداد نتيجة الإصابة بجلطات الدم التي تنتقل إلى الرئتين من الأوردة العميقة في الساقين، ونظرًا لكون الجلطات تمنع تدفق الدم إلى الرئتين فيمكن أن يكون هذا الأمر مهددًا للحياة، لذا فإن العلاج الفوري يُعد ضروريًا لتقليل خطر الوفاة، كما يساهم اتباع الاحتياطات اللازمة لمنع تجلط الدم في الساقين على الحماية من خطر الانسداد الرئوي وبالتالي جلطة الرئة، ويرافق جلطة الرئة عددًا من العلامات التي يمكن أن تتفاوت بدرجة كبيرة اعتمادًا على مقدار إصابة الرئة بالانسداد، وحجم الجلطات، وما إذا كان المصاب يعاني من أمراض أخرى في الرئة أو القلب، وتشمل العلامات الشائعة ما يلي:[١]
- ضيق في التنفس يظهر عادةً بصورة مفاجئة ويزداد سوءًا مع القيام بالمجهود البدني.
- ألم في الصدر مشابه لألم الإصابة بنوبة قلبية، وغالبًا ما يكون حادًا عند التنفس بعمق، مما يعيق قدرة المصاب على ذلك، ويمكن الشعور به أيضًا عند السعال أو الانحناء.
- ألم أو تورم في ساق واحدة أو كليهما، وعادةً ما يحدث في ربلة أو بطة الساق بسبب تجلط الدم في الأوردة العميقة فيها.
- السعال المصحوب للبلغم والدم.
- تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب.
- الدوخة أو الحمى.
- التعرق المفرط.
- زيادة رطوبة الجلد وتغير لونه إلى اللون الأزرق.
ما أسباب حدوث جلطة الرئة؟
يعود السبب في الإصابة بجلطة الرئة إلى تشّكل ما يُعرف بالصِمّة Embolus، التي تدل على وجود جلطة دموية تمنع تدفق الدم عبر الشريان الذي يغذي الرئتين، ويمكن أن تبدأ الجلطة الدموية في الذراع أو الساق ونتيجة للإصابة بما يُعرف بالتخثر الوريدي العميق، وفيما بعد تتحرر الجلطة الدموية وتنتقل عبر الدورة الدموية إلى الرئتين، ونتيجةً لضيق الأوعية الدموية الرئوية تواجه الجلطة الدموية صعوبة في المرور عبرها، مما يتسبب في تكوّن الانصمام الرئوي، ويترتب على ذلك حجب الدم عن التدفق إلى جزء من الرئة، وبالتالي موت هذا الجزء نتيجة نقص التروية الرئوية والأكسجين، ومن النادر أن يتشكّل هذا الانسداد الرئوي بفعل تراكم المواد الدهنية أو الجسيمات الأخرى التي تدخل مجرى الدم، لكن هنالك مجموعة من العوامل والأسباب التي تلعب دورًا في زيادة خطر حدوث جلطة الرئة، وفيما يلي أهمها:[٢]
- العمر: كلما تقدم الشخص في العمر زادت فرصة إصابته بالانصمام الرئوي أو جلطة الرئة.
- الإصابة بجلطات الدم سابقًا: فالأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بتجلط الدم، لديهم فرصة أعلى للإصابة بالجلطات الرئوية، وكذلك الأشخاص الذين لديهم جلطة دموية في الساق أو الذراع، أو أصيبوا سابقًا بجلطة رئوية.
- بعض الإجراءات الطبية والجراحية: يمكن أن تُسبب بعض الإجراءات الطبية الجراحية تلف في الأوعية الدموية، مما ينتج عنه تضيّق هذه الأوعية من الداخل وزيادة فرصة تكوّن الجلطة الدموية.
- قلة النشاط البدني: كلما زادت فترات الخمول والكسل ورحلات السفر الطويلة، كلما زادت احتمالية الإصابة بجلطات الأوردة العميقة نتيجة تجمع الدم في الأجزاء السفلية من الجسم لفترة زمنية أطول من المعتاد، وبالتالي زاد خطر الإصابة بالجلطة الرئوية.
- عوامل إضافية: إلى جانب العوامل السابقة يمكن لخطر الإصابة بجلطات الرئة أن يزداد لدى المصابين بالسرطان، أو أمراض الأمعاء الالتهابية، أو السمنة، أو الذين لديهم أجهزة تنظيم ضربات القلب، أو الذين خضعوا لقسطرة الأوردة، والذين يأخذون مكملات هرمون الأستروجين، ولدى المدخنين والحوامل أيضًا.
كيف يتم تشخيص الإصابة بجلطة الرئة؟
عادةً ما يواجه الأطباء صعوبة في تشخيص الإصابة بجلطة الرئة، خاصةً إذا كان المصاب يعاني مُسبقًا من مشكلة صحية في الرئة أو القلب؛ مثل انتفاخ الرئة أو ارتفاع ضغط الدم، وغالبًا ما يحاول الطبيب تشخيص الإصابة عبر سؤال المصاب عن الأعراض والعلامات التي يعاني منها، وتاريخه الطبي العام، وما إذا كان مُصابًا بأي مشاكل صحية أخرى، وإلى جانب ذلك قد يلجأ الطبيب إلى استخدام عدد من الاختبارات لاكتشاف وتحديد أسباب ظهور العلامات والأعراض التي يشكو منها المصاب، وتشمل هذه الاختبارات ما يلي:[٣]
- تخطيط كهربية القلب ECG: يساعد هذا الإجراء على اختبار النشاط الكهربائي للقلب ويكشف عن طبيعة نبضات القلب.
- تصوير الصدر بالأشعة السينية X-Ray: يسمح هذا الإجراء غير الجراحي للطبيب برؤية قلب المصاب ورئتيه بصورة أكثر وضوحًا، إضافةً إلى التحقق مما إذا كان هناك أي مشاكل في العظام حول الرئتين.
- التصوير المقطعي المحوسب CT: يمنح هذا الاختبار الطبيب القدرة على رؤية صور مقطعية للرئتين.
- التصوير بالرنين المغناطيسي MRI: يعتمد إجراء الرنين المغناطيسي على الاستعانة بموجات الراديو والمجال المغناطيسي لالتقاط صور مفصلة لكل من القلب والرئتين.
- تصوير الأوعية الرئوية: يتضمن هذا الاختبار إجراء شق جراحي صغير ليتمكن الطبيب من خلاله بتوجيه الأدوات الطبية الخاصة عبر الأوردة، كما يتم حقن المصاب بمادة خاصة تُعرف باسم صبغة التباين بهدف منح الطبيب صورًا أكثر وضوحًا للأوعية الدموية الرئوية.
- تصوير الأوردة: يعتمد هذا الإجراء على استخدام أشعة سينية خاصة لتصوير الأوردة في الساقين.
- تصوير الموجات فوق الصوتية المزدوجة: يقوم هذا الاختبار على تصوير الأوعية الدموية باستخدام الموجات فوق الصوتية عالية التردد، والهدف منه تقييم تدفق الدم والأوعية الدموية في الساقين، إلى جانب وجود جهاز كمبيوتر لخلق صور للأوعية الدموية، والأنسجة، والأعضاء.[٤]
- اختبارات الدم: تُستخدم اختبارات الدم للتحقق من حالة تخثر الدم، بما في ذلك اختبار مستوى دي دايمر، واختبار الأمراض الوراثية التي يمكن أن تساهم في الإصابة بتخثر الدم غير الطبيعي، إضافةً إلى فحص غازات الدم الشرياني لمعرفة كمية الأكسجين في الدم.[٤]
- فحص التهوية والتروية (V / Q): في هذا الاختبار الإشعاعي النووي تُستخدم كمية صغيرة من مادة مشعة للمساعدة في فحص الرئتين، ويقوم فحص التهوية بتقييم التهوية أو حركة الهواء داخل وخارج القصبات الهوائية والقُصيبات الهوائية، بينما يقوم فحص التروية بتقييم تدفق الدم داخل الرئتين.[٤]
تعرف على مضاعفات جلطة الرئة
يمكن أن يترتب على الإصابة بجلطة الرئة عدد من المضاعفات التي تتفاوت في شدتها، وفيما يلي أبرزها:[٥]
- تكرار الإصابة بالجلطة الرئوية: أثبتت إحدى الدراسات أن نسبة الأشخاص الذين أُصيبوا من قبل بالجلطة الرئوية وتوقفوا عن تناول الأدوية المضادة للتخثر كالوارفارين ثم أصيب بالجلطة الرئوية مرة أخرى قد تجاوزت 22%، علمًا أن استمرار تناول هذه الأدوية يُسبب بعض المضاعفات الأخرى المرتبطة بالنزيف.
- توقف القلب: يمكن أن تُسبب الجلطة الرئوية الإصابة بالسكتة القلبية، والتي بدورها تزيد من احتمالية الموت المبكر.
- الانصباب الجنبي: يُعرف أيضًا بالارتشاح البِلّوري ويعني تجمع السوائل بين طبقات غشاء الجنبة، وهي أغشية رقيقة تحيط بالرئتين، ويرافق هذا المرض بعض الأعراض منها ضيق التنفس، والسعال الجاف، وألم الصدر.
- الاحتشاء الرئوي: وهو أحد أخطر مضاعفات الانسداد الرئوي ويُعني موت أنسجة الرئة، ويحدث عندما يتم منع الدم المؤكسج من الوصول إلى أنسجة الرئة وتغذيتها، وعادةً ما يحدث الاحتشاء الرئوي نتيجة الإصابة بجلطات كبيرة؛ إذ إن الجلطات الصغيرة غالبًا ما تتفكك ويمتصها الجسم.
- النزيف الشديد: يمكن أن يترتب على استخدام الأدوية المميعة كعلاج لجلطة الرئة حصول نزيف شديد في أجزاء الجسم المختلفة، منها الجهاز الهضمي والدماغ، وتشتمل أعراض نزيف الجهاز الهضمي على تقيؤ ما يشبه القهوة المطحونة، وظهور دم أحمر فاتح في البراز، وألم في البطن، بينما تتمثل أعراض نزيف الدماغ في الصداع الشديد، وتغيرات مفاجئة في الرؤية، وفقدان مفاجئ للحركة أو الشعور بالساقين والذراعين، وفقدان الذاكرة أو الارتباك.[٦]
- مضاعفات إضافية: تشتمل هذه المضاعفات على انخفاض النشاط الكهربائي للقلب، وعدم انتظام ضربات القلب الأذيني أو البطيني، وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي الثانوي، ونقص تأكسج الدم الشديد، وقلة الصفائح الدموية الناتجة عن الهيبارين، والتهاب الوريد الخُثاري.[٧]
أهم طرق علاج جلطة الرئة
تتطلب الإصابة بجلطة الرئة تدخلًا طبيًا عاجلًا لتجنب حدوث المضاعفات الخطيرة المرافقة لها، وتهدف طرق العلاج المتبعة إلى تفتيت الجلطات والمساعدة في منع تكونها مرةً أخرى، وتشمل طرق العلاج هذه كل من الأدوية والإجراءات الجراحية:[٨]
- الأدوية: تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج جلطة الرئة كلًا من:
- الأدوية المضادة للتخثر: غالبًا ما يصف الأطباء للمصابين بجلطة الرئة الأدوية المضادة للتخثر أو مميعات الدم لمنع زيادة حجم الجلطات الدموية، وتقليل فرصة تكوّن جلطات دموية جديدة، ويمكن الحصول على هذه الأدوية عن طريق الحقن أو عبر الوريد، لكن الحذر واجب عند إعطاء هذه الأدوية بسبب إمكانية تسببها بحدوث النزيف، خاصةً إذا كنت تتناول إلى جانبها أدوية أخرى تُسبب سيولة وميوعة الدم مثل الأسبرين،[٨] ومن أكثر الأدوية المضادة للتخثر استخدامًا ما يلي:[٩]
-
- الوارفارين: يأتي الوارفارين على شكل أقراص، ويتم تناوله عن طريق الفم.
- الهيبارين: دواء سائل يتم إعطاؤه للمصاب إما من خلال الوريد IV أو عن طريق الحقن تحت الجلد في المستشفى.
- الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي: يُحقن الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي تحت الجلد، ويتم إعطاؤه مرة أو مرتين في اليوم، ويمكن للمصاب تناوله في المنزل.
- فوندابارينوكس Fondaparinux: دواء جديد يُحقن تحت الجلد مرة واحدة يوميًا.
- الأدوية الحالّة للخثرة: أدوية بوسعها إذابة أو حل جلطات الدم، وغالبًا ما توصف للأشخاص المصابين بجلطات كبيرة تسبب أعراضًا شديدة أو مضاعفات خطيرة أخرى، لكن يمكنها أن تسبب نزيفًا مفاجئًا، لذا يتم استخدامها إذا كان الانصمام الرئوي خطيرًا ومهددًا للحياة.[٨]
- استئصال الصمة: يُعد استئصال الصمة أحد الإجراءات الجراحية التي يلجأ إليها الأطباء في الحالات الحرجة جدًا من جلطة الرئة، وخلال هذا الإجراء يُدخل الطبيب أنبوب رفيع ومرن في الوريد في فخذ المصاب أو ذراعه، ويقوم بتوجيهه إلى الرئتين لإزالة الجلطة، أو استخدام دواء لتفكيكها وحلها.
- مرشح الوريد الأجوف السفلي: يُعرف الوريد الأجوف السفلي بأنه وريد كبير ينقل الدم من الجزء السفلي من الجسم إلى القلب، وعادةً ما يلجأ الطبيب إلى وضع مرشح فيه لوقف الجلطات قبل أن تصل إلى الرئتين، أي أن هذا الإجراء لن يمنع تكوّن الجلطات بل سيمنعها من الوصول إلى الرئتين، ويمكن أن تكون هناك حاجة إلى هذا الإجراء عندما لا يمكن استخدام مميعات الدم بسبب إجراء عملية جراحية حديثة، أو الإصابة بسكتة دماغية ناتجة عن نزيف، أو الإصابة بنزيف كبير في منطقة أخرى من الجسم.
أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة رئتيك: تناولها
يلعب النظام الغذائي السليم دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجسم ككل بما في ذلك الرئتين، ومن الأمثلة على الأطعمة التي يمكنك تناولها لتعزيز ودعم صحة رئتيك ما يلي:[١٠]
- الشمندر: يحتوي جذر نبات الشمندر على مركبات تعمل على تحسين وظائف الرئة، ومنها النترات التي لها فاعلية في دعم وظائف الرئة؛ وذلك من خلال دورها إراحة الأوعية الدموية، وتقليل ضغط الدم، وتحسين امتصاص الأكسجين، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الشمندر على نسبة جيدة من المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين ج، ومضادات الأكسدة الكاروتينية، والتي تُعد جميعها ضرورية لصحة الرئة.
- التفاح: أظهرت بعض الدراسات أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف الرئة وتقليل خطر الإصابة بعدد من أمراض الرئة، وسبب ذلك احتواء التفاح على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد وفيتامين ج.
- اليقطين: يحتوي اليقطين على نسبة جيدة من المركبات النباتية التي تعزز صحة الرئة، والتي منها أهمها مركبات الكاروتينات؛ كبيتا كاروتين، واللوتين، والزيازانثين، والتي تمتلك جميعها خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.
- الكركم: يكثر استخدام الكركم في دعم وتعزيز الصحة العامة؛ وذلك لتأثيراته القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وقد أكدت العديد من الدراسات فاعليته أيضًا في تحسين وظائف الرئة.
- البندورة: تحتوي البندورة على نسبة عالية من مركب الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الكاروتينية التي أثبتت فاعليتها في تحسين صحة الرئة.
بوسعك التعرف على المزيد من الأطعمة المفيدة للرئتين عبر قراءة: أطعمة مفيدة لصحة رئيتيك.
قد يُهِمُّكَ: نصائح هامة للوقاية من جلطة الرئة
نظرًا لارتباط حدوث الانصمام أو الجلطة الرئوية بجلطات الأوردة العميقة في الساقين، فإن الوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هو الأساس في الوقاية من جلطة الرئة، ومن أهم النصائح التي يمكنها أن تحميك من خطر الإصابة بكلا النوعين من الجلطات ما يلي:[٤]
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
- الحفاظ على وزن الجسم صحيًا.
- تناول الأدوية الموصوفة بانتظام والالتزام بجرعاتها العلاجية.
- الإقلاع عن التدخين.
- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالجلطات.
ومن أبرز الطرق المتبعة للوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة بصورةٍ خاصة ما يلي:[٦]
- ارتداء الجوارب الضاغطة والمرنة التي تضغط على الأوردة وتمنع الدم من التدفق للخلف.
- المبادرة للحركة والنشاط في أسرع وقت ممكن بعد الجراحة أو المرض لمنع تكوّن الجلطات وتنشيط الدورة الدموية.
- تناول الأدوية المضادة للتخثر، والتي غالبًا ما تُوصف للمصابين بجلطات الأوردة العميقة للمساعدة على منع الإصابة بالجلطات مرة أخرى.
المراجع
- ↑ "Pulmonary embolism", mayoclinic, 13/6/2020, Retrieved 3/4/2021. Edited.
- ↑ Peter Crosta (22/1/2018), "What's to know about pulmonary embolism?", medicalnewstoday, Retrieved 3/4/2021. Edited.
- ↑ Brian Krans (14/11/2019), "Pulmonary Embolism", healthline, Retrieved 3/4/2021. Edited.
- ^ أ ب ت ث "Pulmonary Embolism", hopkinsmedicine, Retrieved 3/4/2021. Edited.
- ↑ James Roland (29/9/2018), "Complications of Pulmonary Embolism", healthline, Retrieved 3/4/2021. Edited.
- ^ أ ب "Pulmonary Embolism", cedars-sinai, Retrieved 3/4/2021. Edited.
- ↑ Daniel R Ouellette (18/9/2020), "What are complications of pulmonary embolism (PE)?", medscape, Retrieved 3/4/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Pulmonary Embolism", medlineplus, 8/12/2020, Retrieved 3/4/2021. Edited.
- ↑ "Pulmonary Embolism", clevelandclinic, 26/2/2019, Retrieved 3/4/2021. Edited.
- ↑ Jillian Kubala (24/6/2020), "The 20 Best Foods for Lung Health", healthline, Retrieved 4/4/2021. Edited.