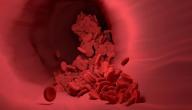محتويات
- ١ التهاب الكبد الوبائي ج
- ٢ مراحل التهاب الكبد الوبائي ج
- ٣ أعراض التهاب الكبد الوبائي ج
- ٤ أسباب التهاب الكبد الوبائي ج
- ٥ عوامل الخطر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ج
- ٦ مضاعفات التهاب الكبد الوبائي ج
- ٧ تشخيص التهاب الكبد الوبائي ج
- ٨ علاج التهاب الكبد الوبائي ج
- ٩ الوقاية من التهاب الكبد الوبائي ج
- ١٠ مَآل مرضى التهاب الكبد الوبائي ج
- ١١ المراجع
التهاب الكبد الوبائي ج
يعرف التهاب الكبد الوبائي ج بأنه مرض ناجم عن عدوى فيروسية تصيب الكبد، ويعرف هذا الفيروس بانتقاله بين الأفراد عبر الدّم، لذلك تحدث معظم حالات الإصابة في وقتنا الحالي جرّاء مشاركة الإبر والمعدات الأخرى المستخدمة في تعاطي المخدرات، وعمومًا يكون التهاب الكبد الوبائي ج مرضًا قصير الأمد لبعض الأفراد، بيد أنه يصبح عدوى مزمنة طويلة الأمد عند نسبة تفوق الـ 50% من المرضى، وهو معروف بأنه مرض خطير مسبب لمضاعفات صحية طويلة المدى تؤدي أحيانًا إلى الوفاة، ولا يتفطن الكثير من النّاس إلى إصابتهم بالعدوى لأنهم لا يكونون مرضى سريريًا أيّ لا تظهر عليهم أعراض في البداية، ولا يوجد حتى الآن أي لقاح واقٍ من هذا المرض الفيروسي، بيد أن الإنسان قادر على وقاية نفسه عبر الابتعاد عن السلوكيات والممارسات المسببة للعدوى. [١]
مراحل التهاب الكبد الوبائي ج
يؤثر فيروس التهاب الكبد الوبائي ج على الأشخاص بأوجه مختلفة ومراحل متعددة وهي: [٢]
- مرحلة الحضانة: تمتد هذه المرحلة بين أوّلِ تعرضٍ إلى الفيروس وبين بداية المرض، فقد تستمر لمدة تتراوح بين 14-80 يومًا، بيد أنّ متوسط مرحلة الحضانة عادةً هو 45 يومًا.
- التهاب الكبد الحاد ج: يكون التهاب الكبد الحاد ج قصير الأمد؛ إذ يمتد على مدارِ الستةِ الأشهرِ الأولى التاليةِ لدخولَ الفيروس إلى الجسم، وبعد ذلك إما يشفى المرضى المصابون به، وإما يختفي تلقائيًا، وإما يصبح عدوى طويلة الأمد.
- التهاب الكبد المزمن ج: يصاب الإنسان بالتهاب الكبد المزمن ج إذا انقضت الأشهر السّتة دون أن يتخلص جسمه من الفيروس، وهذا الأمر يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل؛ تليّف الكبد أو سرطانه.
أعراض التهاب الكبد الوبائي ج
تندرج الأعراض الشائعة لالتهاب الكبد الوبائي ج ضمن مرحلتين هما:
- الأعراض المبكرة: تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC إلى عدم ظهور أي أعراض عند 80% لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد الحاد ج، وفي بعض الحالات يحتمل أن يصاب مرضى آخرون بأعراض بارزة بعد مدة وجيزة من العدوى، وتتفاوت تلك الأعراض بين الخفيفة والشديدة، وهي تشمل كلًّا من الحمى والشعور بالتعب وانخفاض الشهية، وقد تترافق هذا الأعراض مع أعراض أخرى تصيب المريض مثل؛ المعاناة من الغثيان أو القيء، والإصابة بآلام المعدة، والمعاناة من آلام المفاصل أو العضلات، وحدوث اضطرابات في حركات الأمعاء والتبول واصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)، وعمومًا تظهر الأعراض المبكرة عند المريض خلال مدة تتراوح بين 6-7 أسابيع من حدوث العدوى بالفيروس.[٣]
- الأعراض المتأخرة: يتأخر ظهور أعراض التهاب الكبد الوبائي ج عند بعض المرضى، فلا تظهر عليهم إلا بعد انقضاء مدة تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات، ويُعزى هذا الأمر إلى استغراق الفيروس عدة سنوات كي يسبب تلفًا وضررًا في الكبد. [٣]
أسباب التهاب الكبد الوبائي ج
يصاب الإنسان بالتهاب الكبد الوبائي ج نتيجة عدوى فيروسية لا تنتقل بين الأفراد إلّا عبر الدّم الملّوث؛ فهذا الفيروس لا ينتقل أبدًا عبر التعرض إلى رذاذ المصاب أو مشاركته الطعام أو التعرض للدغات البعوض، وعمومًا تبقى الفيروسات غير نشطةٍ حتى تدخل الخلايا الحيّة للكائن المضيف، حيث تستغلّ بنية الخلية للتكاثر، ويعني هذا الأمر أن عدوى فيروس التهاب الكبد ج تتكون من ملايينَ أو ملياراتِ نسخِ الفيروس المنتشرة داخل الجسم، ولا ينتقل المرض بين النّاس إلّا بعد دخول دمِ المريض الملوّث بالفيروس إلى جسم الشخص السليم، ولا يتطلب حدوث العدوى غالبًا إلّا لُطخةً صغيرةً من الدم غير مرئيةٍ بالعين المجردة، إذ إنها تحتوي على مئات الجزئيات من الفيروس، لذلك يكون استخدام الحقن الملوّثة سواء الطبية منها أم المستعملة في تعاطي المخدرات، السبب الرئيس لأغلب حالات الإصابة بالتهاب الكبد ج. [٤]
عوامل الخطر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ج
يزداد خطر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ج في الحالات التالية: [٥]
- العمل في مجال الرعاية الصحية، إذ يرتفع احتمال التعرض إلى دم أحد المصابين بهذا المرض، لا سيما إذا اخترقت جسمَ الشخص أبرةٌ ملوثة بدمٍ مصابٍ.
- تعاطي المخدرات عبر الحقن أو الاستنشاق.
- الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
- الخضوع لعمليات وشم الجسم أو ثقبه (بهدف وضع أقراط ومجوهرات مثلًا) باستخدام معدات ملوثة وغير معقّمة.
- تلقي علاج غسل الكلى على مدار مدة طويلة.
- ولادة الشخص بين عامي 1945 و1965، فهذه الفئة العمرية لديها أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ج.
- ولادة الشخص من أمّ مصابة بالتهاب الكبد ج.
- الأفراد الذين تلقوا دمًا مُتبرَّعًا أو خضعوا لعملية زرع عضوٍ قبل عام 1992.
مضاعفات التهاب الكبد الوبائي ج
يتسبب التهاب الكبد ج، إذا تُرك دون علاج، في معاناة المريض من مضاعفات خطيرة أبرزها: [٦]
- تليّف الكبد: يعرف تليّف الكبد بأنه حالة مرضية مؤديةٌ إلى تدهور صحة الكبد وتراجع قدرته على آداء وظائفه الطبيعية، ويرجع تليّف الكبد إلى استبدال النسيج النُدبي لأنسجة الكبد السليمة، وهو يعيق جزئيًا تدفق الدم عبر الكبد، ومع أن الكبد يستمر في آداء وظائفه في المراحل الأولى من التليّف، فإن تفاقم هذه الحالة يؤدي تدريجيًا إلى معاناة المريض من فشل الكبد.
- فشل الكبد: يطلق على فشل الكبد مصطلح المرحلة النهائية لمرض الكبد، وهو يتطور عادة على مدار شهور أو سنوات أو عقود، مسببًا عجز الكبد عن آداء وظائفه الحيوية أو استبدال الخلايا التالفة.
- سرطان الكبد: يرتفع خطر الإصابة بسرطان الكبد عند الأفراد المصابين بالتهاب الكبد المزمن ج، فإذا ألحقَ الالتهاب المزمن ضررًا شديدًا بالكبد أو حدث تليف الكبد قبل العلاج، فسيظل المريض في خطر الإصابة بسرطان الكبد حتى بعد خضوعه للعلاج.
تشخيص التهاب الكبد الوبائي ج
ثمة مجموعة من تحاليل الدم المستخدمة في تشخيص الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ج، وتحديد دورة العلاج المناسبة ومراقبة تقدم المرض وعملية الشفاء، وتتضمن أبرز تلك التحاليل كلًّا مما يلي: [٧]
تحاليل الأجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد ج
يصيب فيروس التهاب الكبد ج خلايا الكبد عند الإنسان، فيستجيب جهاز المناعة في الجسم عبر إطلاق الأجسام المضادة للتعامل مع الفيروسات بوصفها كائنًا دخيلًا وضارًا، وتكون تلك الأجسام المضادة خاصة بفيروس التهاب الكبد الوبائي، وبذلك، يكون وجودها مؤشرًا على إصابة المرء بهذا المرض، وعمومًا لا تميز تحاليل الأجسام المضادة بين العدوى الحالية أو السابقة عند المريض، لذا، تساهم وسائل التشخيص الأخرى مثل التاريخ الطبي وفحص الأعراض وغيرها، في تحديد إصابته بعدوى نشطة أم سابقة، وتتضمن التحاليل المتبعة ما يلي: [٧]
- تحاليل الدم: تفيد تحاليل المقايسة الامتصاصية المناعية للإنزيم المرتبط، أو ما يعرف بتحاليل إليزا ELISA في اكتشاف الأجسام المضادة في الدّم، وثمة أنواع عديدة لهذه التحاليل، وهي تقوم على فحص عينة الدم بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد ج، فإذا وُجدت في العينة كان المريض مصابًا بالعدوى، وتعرف تحاليل ELISA بأنها شديدة الحساسية؛ إذ تكون نتائجها إيجابية بنسبة 95% إذا احتوى جسم المريض على تلك الأجسام المضادة، وهذه الحساسية العالية تجعل النتائج السلبية مصدر ارتياح وطمأنينة للشخص بشأن خلوِّ جسمه من الفيروس، بيد أنّ هذا الأمر قد ينطوي على احتمال ضئيل بأن تكون النتيجة الإيجابية غير دقيقة ولا صحيحة، لذلك تستدعي الحاجة أحيانًا إلى إجراء تحليل ثانٍ لتأكيد النتائج الأولية أو نفيها. [٧]
- التحليل السريع: يستطيع هذا التحليل اكتشاف وجود فيروس التهاب الكبد ج في عيّنات اللعاب أو الدم بحساسية تبلغ 89% ونوعية تبلغ 100%، ويشير هذا الأمر إلى أن حساسيته ليست بفعالية حساسية تحليل ELISA؛ إذ يحتمل ألّا يقدر على اكتشاف الفيروس أحيانًا، أما إذا جاءت نتائجه إيجابية، فهذا الأمر يؤكد إصابة المريض بالتهاب الكبد ج سواء أكانت الإصابة حالية أم سابقة. [٧]
تحليل الحمض النووي الريبوزي لفيروس التهاب الكبد ج
يستهدف هذا التحليل- المعروف اختصارًا باسم تحليل RNA- اكتشاف الحمض النووي الريبوزي لفيروس التهاب الكبد ج، مما يشير إلى وجوده في الجسم، ويُمكّن هذا التحليل الأطباءّ من معرفة مدى استجابة المريض للعلاج، ويُعزى هذا الأمر إلى قدرته على تحديد كمية الفيروسات في الدم، أو ما يعرف اصطلاحًا بالحمل الفيروسي، ويستخدم تحليل RNA تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل لاكشاف المواد الجينية، وعمومًا تكون نتائج تحليل RNA موزعة على النحو الآتي: [٧]
- نتائج تحليل RNA سلبية: يعني هذا الأمر عدم وجود أيّ عدوى نشطة بفيروس التهاب الكبد ج في الجسم.
- نتائج تحليل RNA إيجابية: يعني هذا الأمر وجود عدوى نشطة بفيروس التهاب الكبد ج في الجسم.
حليل النمط الجيني لفيروس التهاب الكبد ج
يكون تحديد النمط الجيني للفيروس أمرًا بالغ الأهمية؛ نظرًا لأن فيروسات التهاب الكبد ج ذات الاختلافات الجينية تتطلب طرقًا علاجية مختلفة، وعمومًا يحدد الأطباء النمط الجيني للفيروس عبر تحليل مِخبري قائمٍ على طريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل والمستنسخة العكسية RT-PCR، الذي يحلل المادة الجينية للفيروس بهدف تحديد تسلسله، وهذا بدوره يحدد نمطَه الجيني.
تحليل وظائف الكبد
يعتمد هذا التحليل أساسًا على قياس مستويات إنزيمات الكبد في مجرى الدم؛ إذ ترتفع مستويات بعضها عندما يصاب الكبد بالتلف والضرر، ويتحرّى هذا التحليل مستويات إنزيمين رئيسين هما: إنزيم إنزيم ناقلة أمين الألانين ALT، وإنزيم ناقلة أمين الأسبارتات AST، ومع ذلك ينبغي للشخص أن يدرك أن ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد لا يشير دائمًا إلى مشكلات ناجمة عن التهاب الكبد ج، فقد يرتفع بعضها وينخفض بفعل عوامل عديدة. [٨]
علاج التهاب الكبد الوبائي ج
يهدف علاج التهاب الكبد البوائي إلى تخليص الجسم من الفيروسات بحيث لا يُكشف عن أيّ أثر لها بعد مرور 12 أسبوعًا على انتهاء العلاج [٥]، ويعتمد العلاج الحالي على استخدام عدة أدوية معًا، ويكون اختيارُ الدواء المناسب وتحديدُ مدة العلاج تبعًا للنمط الجيني للفيروس؛ فمثلًا تستخدم مضادات الفيروسات القوية في حالات النمط الجيني 1أ المعروف بأنه الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت الحالي يشيع استخدام مضادات الفيروسات ذات المفعول المباشر DAAs، إذ تكمن آلية عملها في استهداف مراحل معينة في دورة حياة الفيروس المسبب للمرض، مما يؤدي إلى إعاقة تكاثر الخلايا الفيروسية، وقد ساهمت هذه الأدوية في زيادة معدلات الشفاء، وتتضمن تأثيراتها الجانبية الشائعة كلًا من الصداع والتعب [٤].
ومن جهة أخرى يلجأ الطبيب إلى عملية زراعة الكبد إذا عانى المريض من مضاعفات خطيرة لالتهاب الكبد المزمن ج، إذ يستبدل الجرّاحون الكبد السليم بالكبد التالف، ويكون الكبد المزروع في حالات كهذه آتيًا إما من متبرعين متوفين، أو من متبرعين أحياء تبرعوا بجزء من كبدهم، ومع ذلك لا تُعالج زراعة الكبد وحدها مرض التهاب الكبد ج؛ إذ يُحتمل أن ترجع العدوى مجددًا، مما يستدعي تناول مضادات الفيروسات للحيولة دون تضرر الكبد المزروع أو تلفه. [٥]
الوقاية من التهاب الكبد الوبائي ج
لا يوجد حتّى السّاعة أيّ علاجٍ فعالٍ وواقٍ من التهاب الكبد الوبائي ج، فالوقاية من هذا المرض تعتمد أساسًا على تجنب خطر انتقال الفيروس في الأماكن العامة وأماكن الرعاية الصحية (مستشفيات أو عيادات)، وضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، مثل؛ المرضى بفيروس نقص المناعة البشرية، ومتعاطي المخدرات، وعمومًا تتضمن الخطوات الضرورية للوقاية من هذا المرض كلًا مما يلي: [٩]
- توخي الحذر جيدًا عند استخدام الحقن الطبية.
- الاعتناء بالنظافة الشخصية، لا سيما نظافة اليدين عند الأفراد العاملين في مجال الرعاية الصحية كالأطباء والجراحين والممرضين.
- إجراء تحاليلَ دمٍ للأفراد المتبرعين بالدم تحسبًا لإصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي ج أو ب، أو مرض الزهري أو فيروس نقص المناعة البشرية.
- التّخلص الآمن من الأدوات الحادة.
- توخي الحذر عند ثقب الجسم، وهذا يعني ضرورة اختيار مكان ذي سمعة مرموقة، وسؤال أصحابهِ بشأن عملية تنظيف المعدّات وتعقيمها. [٥]
من جهة أخرى توصي منظمة الصحة العالميةُ الأفرادَ المصابين بالتهاب الكبد الوبائي ج بضرورة استشارة المراكز الصحية حول خيارات الرعاية والعلاج، وتوصي أيضًا بتلقي لقاحات التهاب الكبد (أ وب) منعًا للعدوى بالفيروسات المسببة لهذين المَرَضين، ولا بدّ لهم كذلك من إجراء الفحوصات الضرورية بهدف التشخيص المبكر لأمراض الكبد المزمنة التي قد تحدث جرّاء التهاب الكبد ج [٩]، وعمومًا يتعايش الكثير من مرضى التهاب الكبد الوبائي ج معه، بيد أنهم يتقيّدون بمجموعة واسعة من الأمور الهامة لتحسين صحتهم مثل: [١٠]
- اتباع نظام غذائي صحيّ، ونيل قسط وافر من الرّاحة يوميًا.
- الامتناع عن استهلاك المشروبات الكحولية منعًا لأي أضرار أخرى بالكبد.
- تجنب الأدوية ذات التأثيرات الجانبية الضّارة بالكبد (هنا ينبغي استشارة الطبيب بشأن تحديد تلك الأدوية).
مَآل مرضى التهاب الكبد الوبائي ج
تعتمد توقعات سير المرض (المَآل) عند المصاب بالتهاب الكبد الوبائي ج على مرحلته عند التشخيص وطريقة معالجته، وهي موضّحة على الشكل الآتي: [١٠]
- يُشفى من المرضى بعد حدوث العدوى الأوليّة نسبةٌ تتراوح بين 15-25% تلقائيًا دون الحاجة إلى العلاج.
- يحتمل ألا يعاني المرضى المصابون بالتهاب الكبد المزمن ج من أي أعراض على مدار سنوات أو عقود.
- تتراوح نسبة المرضى الذين يتطور التهاب الكبد لديهم إلى مرض مزمن بين 75-85%.
- تبدأ مضاعفات المرض، مثل فشل الكبد والسرطان بمجرد ظهور الأعراض على المرضى، ويكون العلاج المضاد للفيروسات قليلَ الفعالية في حالات فشل الكبد، مما يتطلب إجراء عملية زراعة كبدٍ.
- ترتفع فرصة الشفاء أي الاستجابة الفيروسية المستمرة SVR، إلى 90% إذا تلقى المريض علاجًا أوليًا مناسبًا بإحدى تركيبات الأدوية قبل تضرر الكبد وتندُبه، وتنخفض هذه النسبة بالطبع إذا استُخدمت أدوية قديمة أو حدث تليّف الكبد عند المريض أو فشل العلاج الأولي.
- يموت المريض جرّاء التهاب الكبد ج في حالتين هما؛ حدوث فشل الكبد المؤدي إلى الوفاة إذا لم يُعالج، وسرطان الكبد الذي يكون كذلك مميتًا، بيد أن تحسّنَ الفحوصات التشخيصية وتطور الخيارات العلاجية وعمليات زراعة الكبد تساهم كلها في تقليل خطر الوفاة.
المراجع
- ↑ "Hepatitis C ", cdc, Retrieved 2020-5-13. Edited.
- ↑ "Hepatitis C and the Hep C Virus", webmd, Retrieved 2020-5-13. Edited.
- ^ أ ب "What Are the Symptoms and Warning Signs of Hepatitis C?", healthline, Retrieved 2020-5-13. Edited.
- ^ أ ب "Everything you need to know about hepatitis C", medicalnewstoday, Retrieved 2020-5-13. Edited.
- ^ أ ب ت ث "Hepatitis C", mayoclinic, Retrieved 2020-5-13. Edited.
- ↑ "Hepatitis C", niddk.nih, Retrieved 2020-5-14. Edited.
- ^ أ ب ت ث ج "How Hepatitis C Virus Is Diagnosed", verywellhealth, Retrieved 2020-5-14. Edited.
- ↑ "How Hepatitis C Virus Is Diagnosed", everydayhealth, Retrieved 2020-5-14. Edited.
- ^ أ ب "Hepatitis C", who, Retrieved 2020-5-13. Edited.
- ^ أ ب "Hepatitis C (Hep C, HCV)", emedicinehealth, Retrieved 2020-5-13. Edited.