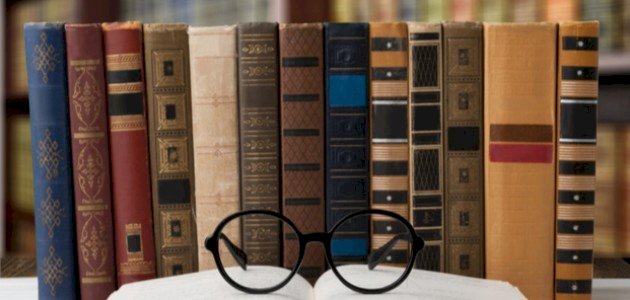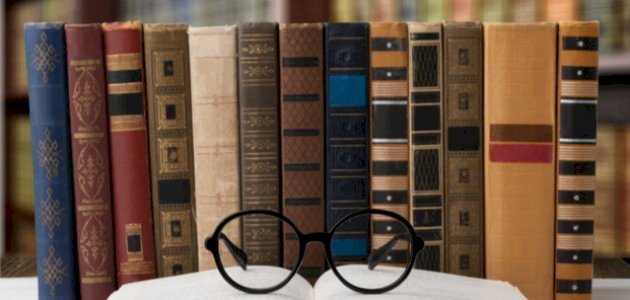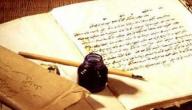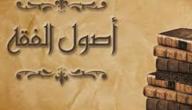محتويات
نشأة علم التفسير
يُعرف علم التفسير على أنه العلم الذي يختص بتفسير القرآن الكريم والكشف عن معاني آياته، أما في اللغة فهو الكشف عن الشيء المُغطى، وعلم التفسير واجب وذلك لقوله تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}[١] ولا شكّ أن الغرض من تفسير القرآن الكريم هو الوصول إلى غاياته ومعانيه الحميدة وللانتفاع به وتطبيق أحكامه التي أمرنا الله تعالى بها،[٢]ومرت نشأته بعدد من المراحل التي سنتناولها بالتفصيل فيما يلي:[٣]
- التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه المفسر الأول للقرآن الكريم، وتفسيره شامل وكامل لكل ما جاء فيه من معتقدات وعبادات ومعاملات، أو غيرها مما يتعلق بالمجتمع أو الأمة أو الجماعة أو العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو علاقة المسلمين ببعضهم البعض في الحرب والسلم، أضف إلى ذلك أن الأحاديث النبوية أتت لتعزز فهم الآيات وتزيد عليها من البيان والتوضيح.
- التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين وذلك بالاعتماد على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أول من تعلم أسباب نزول كل آية من القرآن الكريم ومناسبتها، وحفظوا تلك التفسيرات ودوّنوها، واهتموا بتفسير كل أمر من العبادات والعقائد، وأركان الإسلام وأحكامه وأصوله.
- التفسير بالاعتماد على اللغة ومعاجمها، فمعرفة اللغة العربية هي أساس فهم ومعرفة القرآن الكريم، كونه نزل باللغة العربية، فمتى فُهمَت اللغة العربية كان من السهل التعرُّف على معاني الآيات الكريمة والكلمات الواردة فيها، وتوالت مراحل تطوّر علم التفسير وهو ما ستتعرّف عليه في التطوّر التاريخي لعلم التفسير.
التطور التاريخي لعلم التفسير
يمكن الاستدلال على الكثير عن ماهية علم التفسير من خلال تعريفه لغةً واصطلاحًا ذلك أنه يعني البيان، أي توضيح شيء ما، وجعله مفهومًا، وفيما يلي سنتتبع تطوره التاريخي:[٤]
- التفسير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ظهر علم التفسير مع نزول القرآن الكريم في الجزيرة العربية، فكان القوم يفهمون القرآن بحكم لسانهم العربي والسليقة العربية، وما استعصى عليهم فإنهم يلجؤون به للنبي صلى الله عليه وسلم لتفسيره ليجدوا لديه الإجابة الشافية، فقد تكفل الله بحفظ القرآن في صدر نبيه الكريم، وقد اختلف العلماء بمقدار ما فسره النبي فمنهم من قال أنه عليه الصلاة والسلام فسر الألفاظ وبين المعاني، ومنهم من قال أنه لم يفسر سوى القليل للصحابة، وكان منهج النبي في التفسير بيانًا لمجمل وتوضيحًا لمشكل وتخصيصًا لعام أو تقييدًا لمطلق أو بيانًا لمعنى.
- التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا يدركون معاني القرآن ومراميه، وكان التفاوت واضحًا بينهم في الرتبة فيعود أقلهم علمًا لأكثرهم علمًا، وكانوا يتفاوتون في معرفة المعاني التي وُضعت لها المفردات بحكم تفاوت صحبتهم للنبي ومعرفتهم للعلم الشرعي، وأدوات الفهم لدى كل منهم، ومعرفة أسباب النزول وتفاوت مداركهم العقلية أيضًا، وكان للصحابة مناهج متعددة في التفسير.
- التفسير في عهد التابعين رحمهم الله تعالى وليس هنالك فرق كبير بين هذه المرحلة وما سبقتها لأن التابعين أخذوا التفاسير عن الصحابة، واشترك التابعون مع بعضهم في أسس التفسير المعتمدة، مع وجود أسس أخرى ظهرت بحكم الفتوحات الإسلامية، بالإضافة إلى أنهم اضطروا أحيانًا للاجتهاد والاستنباط في تفسير بعض ما جاء بالقرآن الكريم.
- التفسير في عهد التدوين الذي بدأ في أواخر القرن الهجري الأول، إذ دُوّنَ الحديث النبوي الشريف بمختلف موضوعاته وأبوابه، وانقسم بدوره إلى مراحل عدة وهي كما يلي:
- تدوين التفسير: ودوّن التفسير في هذه المرحلة على أنه باب من أبواب الحديث، كباب الصلاة وباب الزكاة والحج وهكذا.
- استقلال التدوين: إذ أصبح التدوين علمًا مستقلًا بذاته شمل آيات المصحف وسوره حسب ترتيبها.
- اختصار الأسانيد: وهي مرحلة مفصلية وخطيرة في تاريخ علم التفسير، فنُقِلَت الآثار المروية عن السلف دون نسبها إلى قائلها فاختلط الصحيح بالضعيف وظهرت في هذه الفترة الأقاويل بشأن تفسير القرآن الكريم وظهرت الآراء المختلفة دون علم حقيقي به.
- انفتاح باب التفسير على مصراعيه: وهنا اختلط الصحيح والعليل في علم التفسير وما زالت هذه المرحلة قائمة إلى يومنا هذا.
إليك أبرز الأساليب المستخدمة في التفسير
هنالك العديد من الأساليب التي اتُبعَت في تفسير القرآن الكريم وهي تختلف مع تطور علم التفسير، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أسلوب، وللصحابة أسلوب، وللتابعين آخر، وإليك نظرة مفصلة لذلك:[٤]
- اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب بيان المعاني والألفاظ وتوضيح كل ما اختلط على الصحابة معرفته، لكنه لم يذكر النص الكامل في الشرح لكل آية لكي يتفكر العباد في كتاب الله ويحاولوا استنباط المعاني من الدلائل، وفي المجمل لم يكن الرسول يُطنب في تفسير الآية أو يخرج إلى ما لا فائدة في معرفته.
- اعتمد الصحابة رضوان الله عليهم مجموعة من الأساليب في التفسير أولها تفسير القرآن بالقرآن وهو أحسن طرق التفسير، إذ من آيات القرآن ما جاء مجملًا في موضع ومبينًا في آخر، ومنها ما في الإيجاز أو الإطناب، وعموم أو خصوص، وإطلاق أو تقييد، وثانيها تفسير القرآن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي يوضّح المعاني لهم، وثالثها الاجتهاد والاستنباط والذي يلجأ له الصحابة عندما يتعذّر عليهم الفهم من القرآن ولم يجدوا التفسير في السنة.
- اعتمد أسلوب التابعون رحمهم الله في التفسير على تفسير القرآن بالقرآن كما مر في منهج الصحابة، وتفسير القرآن بالسنة النبوية، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، إذ كان التابعون يعودون لأقوالهم ويقدمونها على شروحاتهم هم، واعتمدوا أيضًا على أسلوب الفهم والاجتهاد لعلمهم بلغة العرب، وأخيرًا أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
- اعتمد المفسرون في عهد التدوين على العديد من الأساليب التي اختلفت باختلاف المراحل، ففي تدوين التفسير اتفق على أنه باب من أبواب الحديث، ومرحلة استقلال التدوين وشموليته للآيات والأحاديث، ومرحلة اختصار الأسانيد ونقل الآثار المروية عن السلف دون نسبها إلى قائلها، ومرحلة انفتاح باب التفسير على مصراعيه مما أدخل إليه الغث والسمين والصحيح والعليل.
قائمة بأشهر المفسرين
تزخر المكتبة العربية بمجموعة من أمهات الكتب، تلك التي وضع فيها كُتابها نتاجًا لأكثر من ألف عام لحصيلة المجتهدين والتابعين والمفسرين للقرآن الكريم، بالنقل عمن سبقوهم وصولًا لصحابة الرسول وإياه صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي سنقدم لكَ باقة من أفضل تلك الكتب وأكثرها شهرة في علوم الدين وأسماء مفسريها الذين يعدّون من أشهر علماء التفسير:[٥]
- ابن كثير: الإمام الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمة الله عليه وهو من أشهر التفاسير، وله كتاب "تفسير القرآن العظيم" والمسمى بتفسير ابن كثير نسبةً إلى كاتبه.
- الطبري: هو الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه وله كتاب "جامع البيان في تأويل القرآن"، وتوفي الطبري في السنة 310 للهجرة، ويعتبر من الكتب واسعة الانتشار ويعدّ من أبرز مفسري القرآن وأشهرهم.
- القرطبي: وله كتاب "الجامع لأحكام القرآن" والمبين لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان أو ما يُعرف باسم تفسير القرطبي، والقرطبي هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي والمتوفى سنة 671 للهجرة.
- الإمام الشافعي: وله كتاب "معالم التنزيل" واسم مؤلفه الكامل الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي رحمه الله والمتوفى سنة 516 للهجرة، وهو من أشهر كتب تفاسير القرآن الكريم.
- الصابوني: له كتاب "صفوة التفسير" تأليف الدكتور محمد علي الصابوني.
- الماوردي: له كتاب "تفسير الماوردي - النكت والعيون" لمؤلفه الماوردي البصري.
- البيضاوي: وهو الإمام والعلامة عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، وله كتاب " أنوار التنزيل وأسرار التأويل" والمشهور باسم تفسير البيضاوي.[٦]
- القشيري: وهو الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري الشافعي المولود سنة 376 للهجرة والمتوفى سنة 465 للهجرة، وله كتاب "التيسير في التفسير" أو "التفسير الكبير" والمشهور باسم تفسير القشيري.[٦]
سؤال وجواب
ما أهمية علم التفسير؟
لعلم التفسير أهمية بالغة وذلك لأن الله أنزل القرآن ليتدبره الناس ويفهموه، فبالفهم تستريح الأنفس للعمل به وتطبيق ما فيه وفي ذلك قال تعالى: {كتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْك مُبارَك لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ ولِيَتَذَكرَ أُولُوا الْأَلْبابِ}[٧]، وكذلك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل فامتثل النبي الكريم لأوامر ربه وقام بمهمة التفسير على خير وجه، فكان يوضح للصحابة الكرام ما تعسر عليهم فهمه، كما أن المسلمين حتى يومنا هذا يحتاجون لتفسير كتابهم لمعرفة العبادت والطاعات وفي ذلك قال ابن تيمية: "وحاجة الأمة ماسة إلي فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، والصراط المستقيم"، وأيضًا لكي يعلم طلاب العلم أن التفسير مهم جدًا وأنه الطريق للعمل بكتاب الله وتطبيق منهجه في الحياة.[٨]
ما المصادر التي يعتمد عليها علم التفسير؟
يستند المفسرون إلى أربعة مصادر وهي القرآن الكريم؛ لأنه يشتمل على الإيجاز والإطناب والإجمال والتبيين، وعلى الإطلاق والتقييد على العموم وعلى الخصوص، والمصدر الثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى حياته وسنته بعد وفاته وذلك لأن وظيفة النبي هي البيان كما بين الله في كتابه العزيز، وأما المصدر الثالث فهو الاجتهاد وقوة الاستنباط فإن لم يجد المفسرون في القرآن الكريم ما يبحثون عنه ولم يتيسر لهم أخذه عن النبي مباشرة ًأو بالوساطة فحينئذ يكون الاجتهاد واجبًا على ما تتوافر به شروط الاجتهاد، وأخيرًا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فالقرآن الكريم يتفق مع الإنجيل والتوراة في بعض المسائل، وأبرزها قصص الأنبياء وما يتعلق بالأمم الغابرة.[٩]
ما الشروط التي يجب توافرها في المفسرين؟
إن موضوع التفسير حساس وهام ولا يمكن لأي كان أن يفسر آيات القرآن كما يريد وإنما هنالك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر فيه وهي:[١٠]
- معرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها وذلك لأنها تعين على فهم الآيات التي لا يتوقف فهمها على غير لغة العرب.
- معرفة عادات العرب لأنه تعين على فهم الكثير من الآيات المتصلة بعاداتهم.
- معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة العربية وقت نزول القرآن؛ لأنها تعين في فهم الآيات التي فيها إشارة إلى أعمالهم والرد عليها.
- معرفة أسباب النزول وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات؛ وذلك لأنها تعين على فهم الكثير من الآيات القرآنية.
- قوة الفهم وسعة الإدراك وذلك فضل من الله يعطيه لمن يشاء؛ لأن الآيات تحتاج للتدقيق في المعنى ولا تظهر إلا لمن أتى فهمًا وحفظًا.
- يجب على المفسّر أن يكون عارفًا بأصول الفقه ليميّز بين النص والظاهر، والمجمل والمبين، وبين العام والخاص، وبين المطلق والمقيّد، وليستطيع أن يفهم فحوى الخطاب ولحنه ودليله، وليميّز الناسخ والمنسوخ.[١١]
- يجب أن يمتلك المفسّر العلم الدقيق والمَلَكة التي تؤهله لفهم القرآن الكريم، فقال الطاهر بن عاشور: "واستمداد علم التفسير للمفسر العربي، والمولد، من المجموع الملتئم من علم العربية، وعلم الآثار، ومن أخبار العرب، وأصول الفقه، وعلم القراءات".[١١]
المراجع
- ↑ سورة ص، آية:29
- ↑ ابن عثيمين، أصول في التفسير، صفحة 10. بتصرّف.
- ↑ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، صفحة 14-25. بتصرّف.
- ^ أ ب فهد بن عبدالرحمن الرومي، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، صفحة 14 - 39. بتصرّف.
- ↑ "كتب التفسير أفضل تفاسير القرآن الكريم"، القرآن الكريم ، اطّلع عليه بتاريخ 13/1/2021. بتصرّف.
- ^ أ ب "التفاسير"، نداء الإيمان، اطّلع عليه بتاريخ 23/1/2021. بتصرّف.
- ↑ سورة ص، آية:29
- ↑ عماد علي عبد السميع ، كتاب التيسير في أصول واتجاهات التفسير، صفحة 11- 12. بتصرّف.
- ↑ محمد حسن الذهبي ، علم التفسير، صفحة 19- 24. بتصرّف.
- ↑ محمد الذهبي ، علم التفسير، صفحة 23. بتصرّف.
- ^ أ ب "الضوابط المطلوب توافرها في مفسر القرآن"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 23/1/2021. بتصرّف.