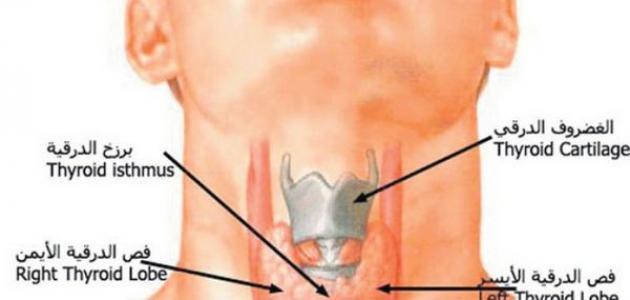محتويات
الغدة النخامية
تقع الغدة النخامية في قاعدة الدماغ وترتبط به عن طريق ساق رفيعة، وهي غدة صماء صغيرة جدًا بحجم حبة البازلاء، وتكمن وظيفتها في إنتاج الهرمونات التي تؤثر على الأعضاء والغدد الأخرى في مجرى الدم مثل الغدد الدرقية، والأعضاء التناسلية، والغدد الكظرية، لذا عادةً ما تُسمى بالغدة الرئيسة لمشاركتها في العديد من العمليات داخل الجسم[١].
ومن المشكلات الشائعة للغدة النخامية حدوث نقص في إنتاج واحد أو أكثر من هرمونات هذه الغدة أو توقف إنتاجه مما يؤثر على الوظائف التي تتحكم بها هذه الهرمونات، والذي يُسمّى بقصور الغدة النخامية، وعادةً ما ترتبط أعراض قصور الغدة النخامية بالهرمون الذي يقل إنتاجه ولكن تشمل أهمها الإعياء، وفقدان الوزن، وانخفاض الدافع الجنسي، وقلة الشهية، وانتفاخ الوجه، والعقم، وقصر القامة عند الأطفال، وعدم انتظام الدورة الشهرية، ويمكن السيطرة على أعراض هذه الحالة والتحكم في إنتاج الهرمونات بواسطة الأدوية التي يحددها الطبيب المختص، وقد يتطلب الأمر زيارة الطبيب على الفور في حال ارتبطت الأعراض السابقة بصداع شديد أو اضطرابات بصرية أو انخفاض ضغط الدم، إذ يمكن أن يكون هذا مؤشرًا على حدوث نزيف مفاجئ في الغدة النخامية مما يتطلب العناية الطبية الفورية[٢].
وقد تحدث أيضًا حالة من فرط نشاط الغدة النخامية عندما تبدأ الغدة بإفراز كميات مفرطة من الهرمونات التي تُنظم بعض وظائف الجسم الرئيسة من النمو، والتمثيل الغذائي، والوظائف الجنسية في الجسم، وضغط الدم، فتؤثر زيادة نشاطها على الكثير من الوظائف المهمة في الجسم مثل[٣]:
- تنظيم نمو الجسم.
- مرحلة البلوغ عند الأطفال.
- تصبّغ الجلد.
- الوظائف الجنسية.
- إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات.
- وظائف الغدة الدرقية.
أسباب فرط نشاط الغدة النخامية
يعود السبب الشائع وراء زيادة نشاط الغدة النخامية إلى وجود أورام غديّة والتي عادةً ما تكون حميدةً بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل اضطرابات ما تحت المهاد، وقد يؤدّي الورم أو السوائل الموجودة حوله إلى زيادة الضغط على الغدة النخامية، والذي يسبب إمّا إنتاجًا أكبر للهرمونات المسببة لفرط نشاط الغدة النخامية أو قلة إنتاج الهرمونات المسببة لقصور الغدة النخامية، والسبب وراء تكوّن تلك الأورام غير معروف للآن، ولكن تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا فيه، إذ إنّ بعض الأورام الوراثية تحدث نتيجةً لحالة تُسمى متلازمة تكوّن الأورام الصمّاوية المتعددة[٣].
الآثار المترتبة على فرط نشاط الغدة النخامية
تختلف مضاعفات نشاط الغدة النخامية وفقًا للسبب الكامن وراء ذلك، كما أنّ بعضها يتطور ببطء مع مرور الوقت ولا يمكن ملاحظته، ومن أهم الآثار الناتجة عن فرط نشاط الغدة النخامية على المدى البعيد[٤]:
- التهاب المفاصل.
- متلازمة النفق الرسغي.
- هشاشة العظام.
- ارتفاع ضغط الدم.
- تصلّب الشرايين.
- فشل وظائف القلب.
- ضخامة النهايات، والتي لا يمكن ملاحظتها لأنّها تتطور ببطء مع الوقت.
- تضخّم اللسان.
- تضخّم الأيدي وضعفها.
- الجلد الدهني.
وقد يؤدي فرط نشاط الغدة النخامية أيضًا إلى بعض الحالات الطبية، والتي تشمل[٣]:
- متلازمة كوشينغ.
- فرط نشاط الغدة الدرقية.
- الورم البرولاكتيني، وهو حالة إنتاج الكثير من هرمون البرولاكتين.
علاج فرط نشاط الغددة النخامية
يختلف علاج فرط نشاط الغدة النخامية وفقًا لتشخيص الحالة، وقد يشمل العلاج إحدى الإجراءات التالية[٣]:
- الأدوية: تساعد الأدوية في السيطرة على فرط النشاط، أو تقليص الورم في حال وجوده كمسبب لفرط نشاط الغدة النخامية، فقد يلجأ الطبيب لاستخدام أدوية لخفض مستويات البرولاكتين، أو أدوية لتقليل كمية هرمون النمو في حالة تضخّم النهايات.
- الجراحة: يلجأ الطبيب في بعض الحالات لإزالة الورم المسبب لفرط نشاط الغدة النخامية، ويسمى هذا النوع من العمليات الجراحية باستئصال الغدد الصماء والتي عادةً ما تكون نسب نجاحها عاليةً وتصل إلى أكثر من 80%، وتكون بإجراء جرح صغير في الشفة العليا أو الأنف للوصول إلى الغدة النخامية وإزالة الورم.
- الإشعاع: يلجأ المريض لخيار العلاج الإشعاعي في حال تعذّر إزالة الورم بواسطة الأدوية، أو بقاء آثار لنسيج الورم بعد العملية الجراحية، ويوجد نوعان من الإشعاعات التي يمكن استخدامها:
- العلاج الإشعاعي التقليدي: ويكون من خلال إعطاء المريض جرعات صغيرة خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، قد يسبب هذا النوع من العلاج الإشعاعي الضرر للأنسجة المحيطة.
- العلاج الإشعاعي التجسيمي: ويكون هذا العلاج خلال جلسة واحدة، وذلك بتوجيه جرعة عالية من الإشعاع إلى الورم، وفي هذا العلاج تقل إمكانية تلف الأنسجة المحيطة، ولكنّه قد يتطلب المتابعة بالعلاجات الهرمونية البديلة بعد ذلك.
مراجع
- ↑ Jill Seladi-Schulman (11 - 6 - 2018), "Pituitary Gland Overview"، healthline, Retrieved 24 - 2 - 2019. Edited.
- ↑ Mayo Clinic Staff (22 - 8 - 2017), "Hypopituitarism"، mayo clinic, Retrieved 24 - 2 - 2019. Edited.
- ^ أ ب ت ث Diana K. Wells (13 - 11 - 2017), "Hyperpituitarism"، healthline, Retrieved 24 - 2 - 2019. Edited.
- ↑ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةrHD9wCC62o