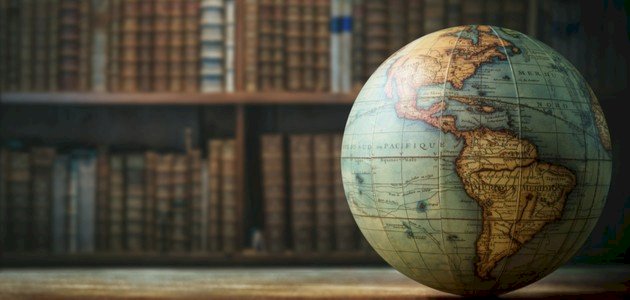محتويات
مفهوم التاريخ عند ابن خلدون
أورد ابن خلدون مفهومًا للتاريخ في مقدمته الشهيرة عام 1377 ميلادي وجاء فيه أن التاريخ هو"فن لعقيدة قيّمة وذات مزايا عدّة، وهدفها هو سرد أخبار الأمم البائدة في سياق عاداتها، وأخبار الأنبياء في سياق حياتهم، وأخبار الملوك في سياق دولهم وسياساتهم"، وقد قسّم ابن خلدون التاريخ إلى قسمين رئيسيين؛ هُما المظهر التاريخي والجوهر التاريخي؛ فالمؤرخ لا يجب عليه أن يدون الأحداث فحسب، وإنّما عليه فحص البيئات والأسس السياسية والأعراف الاجتماعيّة للأحداث التي يدونها، وقد قال ابن خلدون"يوجد التاريخ الحقيقي ليُخبرنا عن الحياة الاجتماعية البشرية، التي تتضمن بيئة العالم وطبيعة تلك البيئة كما تبدو لنا من الأحداث التاريخية، وبذلك يتعامل التاريخ مع الحضارة والوحشية والقبلية، ومع الطرق التي يحصل بها الناس على السُلطة من بعضهم البعض ونتائج هذه السلطة، ويتعامل مع الدول وتسلسلاتها الهرمية، ومهن الناس وأنماط حياتهم، والعلوم والحرف اليدوية الخاصة بهم، وكل ما يحدث في تلك البيئة في ظل الظروف التاريخية"، وقد يهمك هنا معرفة أن منهج ابن خلدون اعتمد أساسًا على النقد العلمي للتاريخ لغرض فهم طبيعة الأحداث التاريخية ودقة الروايات التاريخية التي يعتمدها المؤرخون ومقارنة الروايات ببعضها البعض بأسلوب واقعي.[١]
المنهج التاريخي عند ابن خلدون
يُعد منهج ابن خلدون من أبرز الظواهر الجديرة بالاهتمام من بين مناهج كبار العلماء والفكرين في التاريخ، ابتداءًا من أرسطو وحتّى ديكارت، لكن يجب عدم نسيان أنّ المنهج الخلدوني صعب بعض الشيء، لأنّ بعض العلماء تناولوا أفكاره ومنهجه في القرن التاسع عشر، ليُحلّلوها ويبحثوا بها، ليستنتجوا بعدها العديد من الآراء والنتائج المُتناقضة، كما أن ابن خلدون اتبع منهجه وهو في سن صغير وجمع بين العلوم الدينية والفلسفة والرياضيات والمنطق، بالإضافة إلى خبراته الواسعة في المِهن التي مارسها، وبعض من العلوم التي جمعها من خلال تنقلّه من بلد إلى آخر، وعلى العموم فإن العلماء طرحوا العديد من الآراء الواسعة نتيجة الاختلافات الناتجة عن تحليل منهجه، وكان من بين هذه الآراء ما يلي:[٢]
- قال عالم الاجتماع الأمريكي الأستاذ بيتريم سوروكين أنّ ابن خلدون مُفكّر مثاليّ جدًا.
- وضع الدكتور هاري بارنز ابن خلدون مع المفكرين الذين يسلمون بدور المتناقضات في العلاقات الاجتماعية.
- وجّه عالم الاجتماع الفرنسي جاستون بوتول النظر إلى أسلوب المعالجة المادية الذي لجأ إليه ابن خلدون، وقال بأنه ظاهرة فريدة بين علماء العرب.
- قال الإيطالي فرانسسكو غابرييلي أنّ اعتراف ابن خلدون بالقيم الروحية والاجتماعية للدين جاء ليوازن أو يُصحح الجانب المادي في نظريته عن العصبية.
- مدح المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي وعالم الاجتماع الألماني الأستاذ ناتانيل شميت ما جاء به ابن خلدون أيضًا.
ما موقف ابن خلدون من المؤرخين السابقين؟
بعد أن بدأ ابن خلدون بدراسة التاريخ نظر إلى مناهج ومؤلّفات المؤرّخين السّابقين، ليجد فيها العديد من الأمور التي شعر أنّها مُبالغ بها وبحاجة لإعادة النّظر والتمحيص لإزالة الأخطاء منها، وهذا ظهر بجلاء عند قوله: "إنَّ فحولَ المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيَّامِ وجمعوها وسطروها في صحائف الدفاتِر، وأوعوها وخلطَها المتطفلونَ بدسائس من الباطلِ وهموا فيها وابتدعوهَا، وزخارف منَ الرواياتِ الضعيفة لفقرها ووضعوها، واقتفي تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهَا وأدوها إلينا كما سمعوهَا، ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوالِ ولم يراعوهَا، ولا رفضوا ترهات الأحاديثِ ولا دفعوهَا، فالتحقيق قليل، وطرف التنقيح -في الغالب- كليل، والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل، والبصيرة تنقد الصحيح إِذ تمقل، والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويصقل، والناقد البصير قسطاس نفسهِ في تزيفهم فيما ينقلون أو اعتبارهم".
ولقد حاول ابن خلدون طرح بعض الأمثلة لإثبات وجهة نظره حول الأخطاء والمشاكل الموجودة لدى المؤرخين القدامى، وكان من بين هذه الأمثلة ما جاء عنه من التهويل الواضح في أعداد العساكر والجيوش، والاكاذيب الواردة في الحكايات، وقد استمرّ ابن خلدون في قراءة الكُتب ومناقشة السّابقين لبيان هذه الأخطاء ومُعالجتها، ثم سعى لوضع القواعد التي تحفظ المؤرّخين من الأخطاء.[٣]
وظائف ومؤلفات ابن خلدون
شغل ابن خلدون مركز الدبلوماسي الحكيم، وذهب بنفسه لحل الكثير من النزاعات بين الدول؛ فعلى سبيل المثال، عيّنه السُّلطان محمد بن الأحمر سفيرًا له ليكون وسيط بينه وبين أمير قشتالة للتوصل لعقد صلح بينهما، كما كان صديقًا مقربًا لوزيره لِسان الدّين ابن الخطيب، واستمرّ على وظيفته هكذا مع باقي السلاطين والزّعماء حتى أثناء هجوم المغول على دمشق في تلك الفترة، وخلّف ابن خلدون الكثير من المؤلفات المُهمة للبشرية، ومن أبرز هذه المؤلفات:[٤]
- تاريخ ابن خلدون، أو كما يُسمّى "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر".
- كتاب "شفاء السائل لتهذيب المسائل"، وكان أغناطيوس عبده اليسوعي من بين الذين نشروه وعلقوا عليه.
- مذكراته الذي أخذت اسم التعريف بابن خلدون ورحلاته شرقًا وغربًا.
- مقدمة ابن خلدون.
مَعْلومَة: نبذة عن ابن خلدون
هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد، وُلد في تونس سنة 1332 لأسرة صاحبة علم وأدب، وكان حفاظًا للقرآن الكريم في طفولته، ثم أصبح من أشهر المؤرخين العرب في شمال إفريقيا، ويُعد من علماء التاريخ والاقتصاد، بل هنالك من يصفه بأنه مؤسس علم الاجتماع الحديث، وقد تولى ابن خلدون مهمة الكتابة والوساطة بين الملوك في منطقة المغرب وفي الأندلس، وكان ذلك بعد تخرجه من جامع الزيتونة، وقد ذهب إلى مصر وولّاه السلطان برقوق منصب قضاء المالكية، وبعد مرور سنوات عدة استقال من منصبه، وتفرّغ للتدريس والتصنيف، وتوفي بعد ذلك ليُدفن في باب النصر شمال مدينة القاهرة بمصر، لكن من المعروف أنه اعتزل الحياة في الفترة المتأخرة من عمره نتيجة للصراعات الصاعات والحزن الذي أصابه نتيجة لوفاة أبويه وأحبائه نتيجة وباء الطاعون الذي انتشر سنة 1323 ميلادي، ثمّ تفرّغ لمدة أربعة سنوات في البحث والتنقيب في العلوم الإنسانية، وقد كتب مقدمة ابن خلدون الشهيرة في سنوات عمره الأخيرة،[٤] وفي المناسبة فإن بوسعك التعرف أكثر على ميلاد ونشأة ابن خلدون عبر قراءة أين ولد العلامة ابن خلدون.
المراجع
- ↑ "Ibn Khaldun and the Philosophy of History", philosophynow, Retrieved 20/1/2021. Edited.
- ↑ محمد محمود ربيع، كتاب مناهج البحث في العلوم السياسية، صفحة 55. بتصرّف.
- ↑ "موقف ابن خلدون من المؤرخين السابقين"، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2021. بتصرّف.
- ^ أ ب "ابن خلدون"، المعرفة، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2021. بتصرّف.