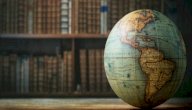محتويات
ابن خلدون
هو عبد الرحمن بن محمد بن ابن خلدون، ولد في تونس عام 1332م/732هـ، وهو من أصول عربية يمنية من حضرموت هاجر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية مع الفتوحات الإسلامية آنذاك، وله قرابة بالصحابي الجليل "وائل بن حجر" الذي كان رفيقًا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهاجر برفقة عائلته من الأندلس لتونس بعد سقوط إشبيلية في عام 1248م، وهو ينتمي إلى عائلة شغلت مناصب سياسية في عهد الأسرة الحفصية في تونس، وانتهى الأمر بوالده إلى أن ينسحب من السياسة والمناصب بانضمامه إلى التصوف والمتصوفين، بالإضافة إلى أخيه يحيى خلدون الذي كان مؤرخًا للمحكمة.[١]
وهو مؤرخ عربي مسلم، يعرف بأنه أحد مؤسسي التاريخ الحديث ومؤسس علم الاجتماع والاقتصاد، نال شهرة كبيرة بفضل مقدمته المعروفة باسمه،[٢] وقد عرف بسعة إطلاعه وثقافته الواسعة بفضل قراءاته وبحثه في الآراء ونقدها وتنقله المستمر بين بلاد العالم، فكان ناقدًا موضوعيًا، فيما برع في علم الاجتماع كونه توصل إلى نظريات فاصلة عن العصبية والعمران وبناء وسقوط الدولة، وهذا لا يقلل من شأن مصنفاته في علوم أخرى كالإدارة والسياسة والقضاء والحساب والمنطق والتاريخ، وسنتحدث في هذا المقال حول هذا العلامة بشيء من التفصيل فيما يتعلق بنسبه، وولادته، وحياته المهمة في السياسة انتهاءً باعتزالها إلى القراءة والتصنيف.[٣]
حياة ابن خلدون العلمية
أكمل ابن خلدون دراساته في الفلسفة والمنطق وبحث في مؤلفات ابن رشد وابن سينا والرازي وتوسي، ومع انتشار وباء الطاعون في عام 1348م/749هـ، الأمر الذي أفقده والديه والكثير من الشيوخ الذين تتلمذ على يدهم، ولم يتبقى أحد يتلقى على يديه العلوم ويتابع بذلك دراسته، فاضطر للاندماج في الوظائف العامة ويسلك نهج كبار عائلته، فاتخذ له وظيفة في بلاط " بني مرين"، وفيما بعد عُيّن عضوًا في مجلس ملك المغرب الأقصى "أبو عنان" في مدينة فاس المغربية، فالتقى فيها بمن تبقى من العلماء الذين هربوا من وباء الطاعون، وبالتالي جدد ابن خلدون معاودة الدراسة والبحث، ولكن الأمور لم تسر كما أراد ابن خلدون، ونتجية لاتصاله بأمير " بجاية" المخلوع قرر أبو عنان ملك المغرب الأقصى حبسه، وبقي في السجن عامين حتى وفاة أبي عنان، وتولى السلطان " أبو سالم أبو الحسن" فأخرجه من السجن ووضعه في مكانة رفيعة، ومنذ ذلك الحين بدأ ابن خلدون يكتب الشعر وينظمه، وبتشجيع من السلطان أبي سالم، وبعد ذلك حفلت حياته بالتنقل بين مصر والأندلس والكثير من البلاد حتى انتهى به الأمر في مصر وتوفي فيها في عام 1409م، ودفن في منطقة حي العباسية في مقابر الصوفية بالقاهرة.
لا شك أن عالم كبير مثل ابن خلدون نشأ في بيت علم وجد، فحفظ القرآن الكريم في وقت مبكر من مرحلة الطفولة على يد والده، فيما تتلمذ على يد علماء مشهورين في عصره منهم: محمد بن عبد المهيمن الحضرمي، وأحمد الزواوي، ومحمد بن العربي الحصاير، وأحمد بن القصر، وغيرهم، فتفقه في القراءات، وعلوم التفسير، والحديق، والفقه المالكي، والأصول، وعلوم اللغة والنحو، والمنطقة، والرياضات، وكان في كلّ علم مثالًا يحتذى به، ونبرس علم ينال إعجاب شيوخه، فيما تأثير بفكر وثقافة بعض شيوخه ومنهم محمد بن عبد المهيمن الحضرمي إمام المحدثين والنحاة في المغرب، ومحمد بن إبراهيم الآبلي المعروف بعلوم الفلسفة والمنطق والطبيعة والرياضيات، ولكن وباء الطاعون لم يترك الأمور تسري على قدم وساق، فقضى على أبوي ابن خلدون وعلى معظم شيوخه، فلم يعد هنالك أحد يتلقى عنه العلم أو يتابع معه دراسته.[١][٤]
حياة ابن خلدون المهنية
بعد وفاة شيوخ ابن خلدون اتجه نحو الوظائف العامة، فعمل في وظيفة كتابية في بلاط بني مرين لكنها لم تتناسب مع طموحه، ثم عينه ملك المغرب الأقصى السلطان أبو عنان عضوًا في مجلسه العلمي في فاس، من هنا عاد لينهل من علمائها الذين نزحوا إليها من تونس والأندلس بلاد المغرب، ثم انقلب به الحال عندما علم السلطان أن ابن خلدون اتصل بأمير بجاية المخلوع أبي عبد الله محمد الحفصي مدبرًا معه مؤامرة لاسترداد ملكه، فسجن العلامة على يد السلطان، ورغم استمالته عطفه للإفراج عنه إلا أنه بقي في السجن حتى عام 1358 للميلاد، فحكم من بعده السلطان أبو سالم، فتولى كتابة سره والترسيل عنه، ففعل ذلك متحررًا من قيد السجع، ناظمًا الشعر الجميل، وبقي في وظيفته سنتين حتى ولاه السلطان خطة المظالم، لكنه لم يهنأ بسبب الوشاة الذين فسّدوا بينه وبين السلطان، ثم ثار رجال الدولة على السلطان وخلعوه، لكن ابن خلدون ظل في مكانه بعد أن تولى الحكم أبوه تاشفين، بل زاد له في رواتبه.
ورغم هذا العز والجاه والمنصب إلا أن طموح ابن خلدون كان أقوى من كل شيء، فقرر السفر إلى غرناطة الأندلسية في مطلع عام 1362 للميلاد، وهناك لقي حفاوة وتكريمًا من سلطان المدينة محمد بن يوسف بن الأحمر، ووزيره لسان الدين بن الخطيب، فكلفه السلطان بالسفارة بينه وبين ملك قشتالة بِطْرُه بن الهنشة بن أذقونش لعقد الصلح بينهما، وقد أدى ابن خلدون مهمته بنجاح كبير، فكافأه السلطان بأرض كبيرة وأمول كثيرة، ولم تدم سعادة ابن خلدون بهذا النعيم بسبب الوشاة والحساد الذين أفسدوا العلاقة مع الوزير والسلطان، عندها أدرك أنه لم يعد له مقامًا في الأندلس كلها، فأرسل له أميرها أبو عبد الله محمد الحفصي بعد أن استرد عرشه طالبًا منه القدوم إلى البلاد، عارضًا عليه أن يوليه الحجابة وفاءً لعهد قديم، فاستقبله السلطان في موكب رسمي وحشد جماهيري مهيب.[٥]
أهم الإنجازات العلمية لابن خلدون
كان لابن خلدون أعمال ومؤلفات عديدة أهمها كتاب العبر ومقدمة ابن خلدون، فكتب في تاريخ البشرية حتى العصر الذي عاش فيه، وفي كتب أخرى تحدث عن تاريخ الشعوب البربرية في المغرب العربي، إذ يعد الأخير كتابًا هامًا جدًا في التاريخ البربري، وقد انتقد البعض هذه المؤلفات ووصفوها بأنها رديئة المصادر، وأن هذه المصادر قد تتناقض في بعض الأحيان، وقد ركز ابن خلدون في نظرته للمجتمع كونه يعد الأب الروحي لعلم الاجتماع على فكرة أن حصول المجتمع على الحضارة والازدهار كنقطة سماها نقطة ارتفاع، فثمة نقطة أخرى تليها سماها نقطة التحلل، وكمثال البرابرة الذين سيطروا على مجتمع أصبح محتلًا، فإنهم يحاولون الانجذاب لقضاياه أكثر مما كان عليه، فيحيون الفنون ويمحون الأمية، أو أنهم يستوعبون ما عندهم من ممارسات ثقافية تناسبهم، وتتكرر هذه العملية في حال غزا البرابرة مجموعة جديدة من البرابرة.
كما تحدث ابن خلدون في مؤلفاته عن الاقتصاد السياسي، وقال أنه مجرد إجراءات بقيمة مضافة، فيُضاف العمل والمهارة للتقنيات لبيع المنتج بسعر أعلى، وأبدى رغبته في مؤلفاته أن يكون لنظام النقد في الإسلام قيمة جوهرية كالذهب والفضة، وحدد الوزن المثالي الدقيق لهما،[١] وفيما يأتي أهم مؤلفات ابن خلدون وهما العبر والمقدمة:[٦][٧]
- مقدمة ابن خلدون: ألف ابن خلدون كمؤسس لعلم العمران البشري كتابة الذي أسماه " مقدمة ابن خلدون"، كمقدمة لكتاب "العبر"، وقد كتب في هذا الكتاب العديد من المواضيع المعرفية العلمية، وتحدث عن القضايا التي تخص البشر وأحوالهم وما لديهم من طبائع ومدى تأثير البئية عليهم، وبالتالي كانت المقدمة ما هي إلا مجموعة من النظريات ذات العلاقة المباشرة بعلم الاجتماع كما يُسمى اليوم.
- كتاب العبر: تحدث في مؤلفه هذا عن التاريخ الخاص بالبرابرة أي التاريخ البربري؛ فهو من أبرز الكتب التي تحدثت في هذا المجال، ويعد مرجعًا رئيسيًا في هذا الموضوع حتى يومنا هذا، وكان الكتاب عبارة عن سبعة مجلدات، وفي نهاية فصوله تناول ابن خلدون التعريف بنفسه وسماه: التعريف بابن خلدون ورحلته في الشرق والغرب.
- مؤلفات أخرى: ومنها:[٣]
- الخبر عن دولة التتر.
- مزيل الملام عن حكام الأنام، وهو رسالة للقضاة.
رحلات ابن خلدون
تنقل ابن خلدون بين عدد من المناطق حول البلاد العربية والأندلس، وأهمهما كانت رحلته وإقامته في غرناطة (الأندلس)، وفي القاهرة (مصر)، ففي غرناطة تلقى ابن خلدون التقدير والاحترام والحفاوة من قبل السلطان "محمد بن يوسف الأحمر"، فكُلف آنذاك بعقد صلح بين السلطان وملك "قشتالة"، فنجح بذلك وحصل على المزيد من الدعم وحسن المعاملة من قبل السلطان الأحمر، ثم انتقل إلى "بجاية"، ورُحّب به فيها، ولكن ثمة من وشوا به لسلطانها فطلب منه العودة لتونس مسقط رأسه، فانتقل بعدها إلى مصر، فاستقبله علماء القاهرة وأهلها استقبالًا يليق به، واستقر بالتدريس في الأزهر الشريف، ومن أهم العلماء الذين تتلمذوا على يديه في مصر " ابن حجر العسقلاني" و" تقي الدين المقريزي"، وعيّنه سلطان مصر " الظاهر برقوق" لتدريس الفقه المالكي في المدرسة المسماه آنذاك " القمصية"، ولكنه أيضًا لم يسلم من الوشاة في مصر، فعزله السلطان من منصبه، وطلب منه السفر لزيارة فلسطين والقدس، وقد وصف رحلته للقدس بأدق التفاصيل في كتابه " التعريف".[٤]
المراجع
- ^ أ ب ت "من هو ابن خلدون - Ibn Khaldun؟"، arageek، اطّلع عليه بتاريخ 5-7-2019. بتصرّف.
- ↑ أسماء سعد الدين (14-7-2013)، "ابن خلدون"، almrsal، اطّلع عليه بتاريخ 5-7-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب بسمة حسن (1-10-2018)، "كتب ابن خلدون"، almrsal، اطّلع عليه بتاريخ 5-7-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب "ابن خلدون.. سيرة ومسيرة (في ذكرى وفاته: 26 من رمضان 808هـ)"، islamonline، اطّلع عليه بتاريخ 5-7-2019. بتصرّف.
- ↑ "ابن خلدون.. سيرة ومسيرة (في ذكرى وفاته: 26 من رمضان 808هـ)"، islamonline، اطّلع عليه بتاريخ 5-7-2019. بتصرّف.
- ↑ "الفيلسوف ابن خلدون.. من غياهب السجن إلى قاضي قضاة مصر"، al-ain، 27-5-2019، اطّلع عليه بتاريخ 5-7-2019. بتصرّف.
- ↑ "ابن خلدون"، shamela، اطّلع عليه بتاريخ 5-7-2019. بتصرّف.