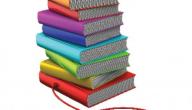محتويات
نظرية المعرفة
نظرية المعرفة هي دراسة لشكل العلوم الإدراكية ومكوناته، من شرح وتمييز ببراهين جوهرية المنطق، ومخاطبة العقل في اعتقاده وإيمانه، وتصور الظواهر الماورائية وتفسير مجرياتها، وتحليل المعرفة الإنسانية من كل زواياها ومحيطها، وتعد نظرية المعرفة قديمة قدم الفلسفة نفسها؛ فتكلم أفلاطون في زمانه حول فرضية العلاقة بين الاعتقاد والمعرفة، ففي نظره أن المعرفة هي اليقين الصادق الذي تقوم عليه الحجج والبراهين، وتهدف نظرية المعرفة إلى إنماء الوعي المستوجب لفهم العلوم والوقائع ضمن إطار الواقع من خلال البرهنة عليه؛ ذلك لأن المعرفة بالشيء تقتضي اليقين به.[١]
تاريخ نظرية المعرفة وتطورها
الإنسان ومنذ وجوده على وجه المعمورة كان متجانسًا مع كل ما يشعر فيه داخله، وحانقًا بكل ما يشاهده، فكل ما يشاهده هو معطيات مجردة، لكن لا يمكن معرفة إن كانت ماهية هذه المعطيات صحيحةً أم لا علاقة لها من الصحة، ومدى درجة إلمام الاعتقاد في الشيء أو أن الحكم عليه غلبه الظن والتخمين. وأخذ التأمل البشري بالكون والوجود يتبلور مع تقدم عجلة الزمان، وتطور عقل الإنسان وإدراكه، وتعددت أدواته التي مكنته من قياس المعلومات التي تحصل عليها من تفكره حتى يصل بها إلى نتيجة أعلى ويقين أكبر، ولقد بحث الفلاسفة في هذه المراحل التي مرّ الفكر البشري بها، وووزعوها في ثلاث مراحل، هي:[٢]
- المرحلة الخرافة: وتسمى بالمرحلة الحسية، امتازت هذه المرحلة بالتفسيرات الخرافية للظواهر، وإرجاع مسوغاتها إلى الأرواح والأوهام، وعُدّت الخرافات مصدر نشوء هذه الظواهر، دون الاجتهاد للوصول إلى أي قاعدة أو مرجع يمكنه تفسير هذه الظواهر علمياً أو عملياً، فغلبت على هذه المرحالة سيطرة الأساطير والخرافات على العقول التي تنسج من نسج الخيال.
- المرحلة الميتافيزيقية: وتسمى بمرحلة الفلسفة النظرية، وفيها ارتحلت البشرية إلى مرحلة أعلى من الإيمان والاعتقاد بالخرافات والأساطير، فكان ظهورها نتيجة توسع حركة الفلسفة اليونانية، فجدد الفلاسفة حينها ملامح الفكر البشري وطوروه، فوضعوا النظريات التي تفسر حدوث الظواهر كنتيجة إلى علل ومسائل غيبية، ويطلق على هذه المرحلة "المرحلة الميتافيزيقية"، وتتكيف في تفسيراتها لكل شيء على الكينونات، فينتج عن ذلك إرجاع أي الحقيقة ظاهرية إلى الماورائيات، أي ما وراء الأشياء الطبيعية.
- المرحلة الواقعية: وتسمى بالعلوم التجريبية، وهي أزهى وأكثر المراحل المعرفية التي توصل إليها الإنسان تطورًا، التي وصل من خلالها الفكر البشري إلى النضج، وهي مرحلة تحكيم العلم وقولبته، أي إرجاع التفسيرات العلمية إلى الظواهر والقوانين والقواعد العلمية لا غير، وذلك من خلال التجارب والاستنتاجات والخروج بنظريات وقوانين من شأنها تفسير الظواهر.
نظرية المعرفة من منظور فلسفي
توضح نظرية المعرفة من الجانب الفلسفي من خلال ثلاثة بنود أساسية:[٣]
محددات نظرية المعرفة
يمكن تعريف المعرفة على أنها مسلّمات ارتبطت بحقائق عامة، وتتحقق بوجود هذه المحددات:[٣]
- الاعتقاد: أو العقيدة، هي أقصى مجال لوصول حالات العقل لليقين المطلق بالشيء، فلا يمكن نقاشه أو الجدال في كينونته ووجوده، فالإيمان به إيمان مطلق لا رجعة عنه.
- الكلمة: الكلمات هي الوسيلة الأولى للتعبير عن العقائد، وهي ما يهيئ البيئة للتناغم بوضوح بين العقيدة والسلوك، مما يشكل المعرفة لدى المرء.
- الاعتقاد والسلوك: سلوك الفرد مرتبط بمبادئ عقيدته وأركانها، فيجد الفلاسفة أن العقيدة هي المحرك الأول لتحديد السلوك وتوجيهه، فإن الخطأ في السلوك قد يكون ناجمًا عند عدم وضوح العقيدة أو خطئها.
قيمة المعرفة
ظهرت ثلاثة مناهج في تقييم المعرفة وهي:[٣]
- منهج الإنكار: رواده السفسطائيون قديماً، وهو مذهب فلسفي ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد، يدّعي متبني أفكاره أنهم من أهل العلم، وأنكروا جميع المعارف الواقعية والمسلمات، وقالوا بأن الإنسان هو الميزان الذي يقاس به كل شيء، وتميزوا بقوة الجدل الذي جرهم أحيانًا إلى إنكار الحقائق.
- منهج الشك: وهو مذهب يتوسط منهجي الإنكار اليقين، فيحاول التوفيق بينهما، فلم ينكر الواقعيات أنكارَا قاطعًاا ولم يثبتها كذلك، بل التزم موقف الشك منها.
- منهج اليقين: وسار على نهجه سقراط وأساتذته وتلاميذه، وتبنوا وجود الحقائق وإمكان الوصول إليها بالمنطق السليم، ويقولون بأنّ كل إنسان قادر على إدراكها والتعرف عليها تعرفًا صحيحًا.
أدوات المعرفة
أما الأدوات التي يمكن من خلالها الوصول لإدراك المعرفة فهي:[٣]
- الحس: إذ يعد من أفضل وسائل الحصول على المصادر المعرفية التي إليها تنتهي المعارف الضرورية.
- العقل: يختلف عن الحس بوجود عدة عمليات ضمن إطار وظائفه هي: الاستنتاج وإدراك المفاهيم، والتحليل والتركيب والتجريد، والانتزاع والتبديل.
- التجربة: هي إحدى الأدوات التي تفيد اليقين بنتيجة كلية، والتجريبيات هي إحدى اليقينيات التي تشكل أساس البراهين العقلية وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة تكرار المشاهدة فيحصل ترسيخ لها في النفس.
- الوحي: تفردت الفلسفة الإسلامية بهذا الجانب من الأدوات المعرفية، إذ اعتبرت أن الوحي من مصادر العلم الذي أوحي إلى النبي من الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام.
التفكير النقلي
ويقصد به العلوم والأفكار والاتجاهات المنقولة عن السابقين جيلاً بعد جيل، وينتج عن هذا الفكر أن يصبح الإنسان معتمدًا اعتمادًا كليًا على تفكير غيره من السابقين وتصبح عنده من المسلمات التي لا يمكن الجدال في صحتها، ويلجأ الفرد لهذه الطريقة في بداية مراحل التعلم، لكن حينما يكون الإنسان قد حصل على القدر المطلوب من المعلومات فإن استمراره في تبني العلم بهذه الطريقة يسبب له أضرارًا منها:[٤]
- قلة الحيلة بسبب اتباع الآخرين في أفكارهم وقواعدهم.
- عدم المقدرة على اتخاذ قرارات باستقلالية عن الآخرين.
- جمود التفكير الشخصي لديه لصغر مساحة الابتكار.
- عدم المقدرة على التفسير والاستنتاج.
- استمرار على الأخطاء السابقة.
المراجع
- ↑ "نظرية المعرفة"، المعرفة، 25-3-2013، اطّلع عليه بتاريخ 12-3-2019.
- ↑ بشار جيدوري، "التطور التاريخي للمعرفة البشرية"، مقال، اطّلع عليه بتاريخ 12-3-2019.
- ^ أ ب ت ث "نظرية المعرفة.. بين الفلاسفة اليونان والفلاسفة المسلمين"، حراء، 21-2-2019، اطّلع عليه بتاريخ 12-3-2019.
- ↑ "نظرية المعرفة"، شرق غرب، 1-7-2014، اطّلع عليه بتاريخ 12-3-2019.