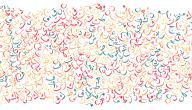- ذات صلة
- احرف النفي
- احرف العلة
علم النحو
كان العرب قديمًا يتحدثون بسليقة لم يحتاجوا معها تبيانًا لقواعد نظم، وبعد أن جاء الإسلام واختلط الأعاجم بالعرب مالت الألسن إلى اللحن، وبدأت الخروج عن أصول الكلام الموروثة عن الأسلاف، وحرصًا من العلماء على الحفاظ على اللسان المبين الذي اختاره الله -جل وعلا- لسانًا للقرآن وضعوا نحوًا ينحوه كل دخيل على اللسان ويلتزم به أبناء العربية، وعكف العلماء على دراسة أصوات اللغة العربية ومفرداتها ووصف تراكيبها، وألفوا كتبًا في ذلك، ووضعوا قواعد تصف اللسان العربي الفصيح وصفًا دقيقًا ومحكمًا[١].
ويعرف النحو لغة بالقصد والطريق، وهو مصدر، وأما اصطلاحًا فقد عرفه ابن السراج بقوله: "النحو إنما أُرِيد به أن ينحو المتكلِّم إذا تعلَّمه كلامَ العرب، وهو علمٌ استخرجه المتقدِّمون فيه مِن استقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة"[٢][١] واختلف في أول من رسم النحو، فقال بعضهم: أبو الأسود الدؤلي، وقيل: نصر بن عاصم الليثي، وقيل: عبد الرحمن بن هرمز، لكن الراجح أنه أبو الأسود الدؤلي، ومرحلة وضع النحو وتكوينه كانت للمدرسة البصرية، ونضج العلم واستقر في ظل النقاشات التي كانت بين المدرستين (ألكوفية والبصرية)، وظهرت مدارس أخرى ساهمت في تطور العلم تطورًا مهمًا مثل المدرسة: البغدادية، والمصرية، والشامية، والأندلسية.[١]
أحرف الجزم
حروف الجزم هي حروف تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وهي على نوعين[٣]:
- ما يجزم فعلًا واحدًا: وهي أربعة أحرف:
- لم: تدخل على الفعل المضارع، تفيد النفي والجزم والقلب، وهي لنفي الماضي مطلقًا، ولا يشترط في نفيها الاستمرار بل يجوز القول لم آتي إلى العمل ثم أتيت، ويجوز أن يصحبها أداة شرط، نحو: (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) [المائدة:76].
- لمّا: تدخل على الفعل المضارع، وتفيد النفي والجزم والقلب، وهي لنفي الماضي المستمر إلى زمن المتكلم، والمنفي بها متوقع الحصول، كقوله تعالى (بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ) [ص:8] والمعنى ما ذاقوه إلى الآن وسوف يذوقونه لاحقًا، ويجوز حذف مجزوم لمّا كقولنا: قاربت المدينة ولمّا، أي: ولمّا أدخلها.
- لام الأمر: يطلب بها حدوث الفعل، نحو: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ) [الطلاق:7]، وهي مكسورة ويحسن إسكانها إذا جاءت بعد الفاء أو الواو العاطفتين، وقد تسكن بعد (ثمّ)، وتدخل على الفعل المسند الغائب، نحو: (ليقم كل بعمله)، ويقل دخولها على المتكلم الجمع أو المفرد كقوله تعالى: (وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) [العنكبوت:12]، ويندر دخولها على المخاطب كقوله تعالى: (فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) [يونس:58].
- لا الناهية: يُطلَب بها الكفّ عن العمل، يكثر دخولها على فعل المخاطب نحو: (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) [آل عمران:8]، ثم الغائب نحو: (لا يركَنَنْ أحدٌ إلى الدَّعَةِ)، ويكثر دخولها أيضًا على الفعل المتكلم المبني للمجهول نحو: (لا نؤخذ على غرّة)، ويندر جزمها للمتكلم المبني للمعلوم
- ما يجزم فعلين: وهي اثنا عشر حرفًا تقسم من حيث دلالتها إلى 6 أقسام، هي:
- ما وُضِعَ لمجرد تعليق الجواب على الشرط: (إن، إذما) وليس لهما محل من الإعراب نحو (إذما ترحل أصحبك، إن تجدَّ تنجح)
- ما وُضِعَ للدلالة على غير العاقل، ثم ضُمِّنَ معنى الشرط: وهي (ما، مهما)
- ما وضع للدلالة على العاقل، ثم ضُمِّنَ معنى (إنْ) الشرطية: نحو: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ) [البقرة:197].
- ما وضع للدلالة على الزمان: (متى، أيّان)، أو المكان: (أين، أنّى، حيثما) ثم ضُمِّنَ معنى الشرط، نحو: (متى تأتِ تجدها في انتظارك)
- ما وضع للدلالة على الحال ثم ضُمِّنَ معنى الشرط: (كيفما) شرط أن يكون الفعلان فيها من لفظ واحد، نحو: (كيفما تعامل الناس يعاملوك).
- ما هو صالح لمعاني الأسماء كلها: (أي) وتتميز بأنها معربة غير مبنية، وهي ملازمة للإضافة، وصالحة لمعنى أسماء الشرط جميعها.
علامات الجزم
يجزم الفعل المضارع بإحدى العلامات الآتية:[٣]
- السكون الظاهر:إذا كان الفعل صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون، مثل: لم تكتبْ الدرس.
- حذف حرف العلة من آخر الفعل: إذا كان الفعل منتهيًا بأحد أحرف العلة يبنى على حذفه، مثل: لا ترَ الشمس.
- حذف النون: إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة المتمثلة في (يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين) فإنه يبنى على حذف النون من آخره، مثل: لم تأكلوا، لم يأكلوا، لم يأكلا، لم تأكلا، لم تأكلي.
- في محل جزم: يكون الفعل المضارع في محل جزم إذا جاء مضارعًا مبنيًا أو ماضيًا.
المراجع
- ^ أ ب ت عبدالله معروف، "النحو العربي نشأته ومدارسه وقضاياه"، alukah، اطّلع عليه بتاريخ 28-6-2019. بتصرّف.
- ↑ ابن السراج (1996م)، الأصول في النحو (الطبعة الثالثة)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 35، الجزء الأول.
- ^ أ ب عصام البيطار (2014)، النحو والصرف، دمشق: منشورات جامعة دمشق، صفحة 273-277. بتصرّف.